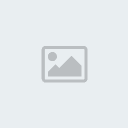د/ علاء الأســواني
على مدى سنوات، عملت طبيبا للأسنان في هيئة حكومية كبرى تضم آلاف العاملين. وفي اليوم الأول بينما كنت أعالج أحد المرضى، انفتح باب العيادة وظهر شخص، قدّم نفسه باسم الدكتور حسين الصيدلي، ثم دعاني لأداء صلاة الظهر جماعة، فاعتذرت حتى أنتهي من عملي ثم أؤدي الصلاة.. ودخلنا في مناقشة كادت تتحول إلى مشادة؛ لأنه أصر على أن أترك المريض لألحق بالصلاة، وأصررت على استئناف العمل.
اكتشفت بعد ذلك أن أفكار الدكتور حسين شائعة بين كل العاملين في الهيئة. كانت حالة التدين على أشدها بينهم. العاملات كلهن محجبات، وقبل أذان الظهر بنصف ساعة على الأقل ينقطع العاملون جميعا تماما عن العمل، ويشرعون في الوضوء وفرش الحصير في الطرقات، استعدادا لأداء صلاة الجماعة. بالإضافة طبعا إلى اشتراكهم في رحلات الحج والعمرة التي تنظمها الهيئة سنويا.
كل هذا لم أكن لأعترض عليه، فما أجمل أن يكون الإنسان متدينا، على أنني سرعان ما اكتشفت أن كثيرا من العاملين -بالرغم من التزامهم الصارم بأداء الفرائض- يرتكبون انحرافات جسيمة كثيرة بدءا من إساءة معاملة الناس والكذب والنفاق وظلم المرؤوسين وحتى الرشوة ونهب المال العام. بل إن الدكتور حسين الصيدلي الذي ألح في دعوتي للصلاة، تبين فيما بعد أنه يتلاعب في الفواتير ويبيع أدوية لحسابه..
إن ما حدث في تلك الهيئة يحدث الآن في مصر كلها.. مظاهر التدين تنتشر في كل مكان، لدرجة جعلت معهد جالوب الأمريكي، في دراسة حديثة له، يعتبر المصريين أكثر الشعوب تدينا على وجه الأرض.. وفي نفس الوقت، فإن مصر تحتل مركزا متقدما في الفساد والرشوة والتحرش الجنسي والغش والنصب والتزوير..
لابد هنا أن نسأل: كيف يمكن أن نكون الأكثر تدينا والأكثر انحرافا في نفس الوقت.. في عام 1664 كتب الكاتب الفرنسي الكبير موليير مسرحية اسمها تارتوف، رسم فيها شخصية رجل دين فاسد يسمى تارتوف، يسعى إلى إشباع شهواته الخسيسة وهو يتظاهر بالتقوى.. وقد ثارت الكنيسة الكاثوليكية آنذاك بشدة ضد موليير ومنعت المسرحية من العرض خمسة أعوام كاملة.. وبرغم المنع، فقد تحولت تارتوف إلى واحدة من كلاسيكيات المسرح، حتى صارت كلمة تارتوف في اللغتين الإنجليزية والفرنسية، تستعمل للإشارة إلى رجل الدين المنافق. والسؤال هنا: هل تحول ملايين المصريين إلى نماذج من تارتوف؟
أعتقد أن المشكلة في مصر أعمق من ذلك.. فالمصريون متدينون فعلا عن إيمان صادق.. لكن كثيرا منهم يمارسون انحرافات بغير أن يؤلمهم ضميرهم الديني. لا يجب التعميم بالطبع، ففي مصر متدينون كثيرون يراقبون ضمائرهم في كل ما يفعلونه: القضاة العظام الذين يخوضون معركة استقلال القضاء دفاعا عن كرامة المصريين وحريتهم، والمستشارة نهى الزيني التي فضحت تزوير الحكومة للانتخابات، والمهندس يحيى حسين الذي خاض معركة ضارية ليحمي المال العام من النهب في صفقة عمر أفندي. وغيرهم كثيرون. كل هؤلاء متدينون بالمعنى الصحيح..
ولكن بالمقابل، فإن مئات الشبان الذين يتحرشون بالسيدات في الشوارع صباح يوم العيد، قد صاموا وصلوا في رمضان.. ضباط الشرطة الذين يعذبون الأبرياء.. الأطباء والممرضات الذين يسيئون معاملة المرضى الفقراء في المستشفيات العامة.. والموظفون الذين يزوّرون بأيديهم نتائج الانتخابات لصالح الحكومة.. والطلبة الذين يمارسون الغش الجماعي.. معظم هؤلاء متدينون وحريصون على أداء الفرائض.. إن المجتمعات تمرض كما يمرض الإنسان.
ومجتمعنا يعاني الآن من انفصال العقيدة عن السلوك.. انفصال التدين عن الأخلاق.. وهذا المرض له أسباب متعددة: أولها النظام الاستبدادي الذي يؤدي بالضرورة إلى شيوع الكذب والغش والنفاق، وثانيا إن قراءة الدين المنتشرة الآن في مصر إجرائية أكثر منها سلوكية. بمعنى أنها لا تقدم الدين باعتباره مرادفا للأخلاق وإنما تختصره في مجموعة إجراءات إذا ما أتمها الإنسان صار متدينا. سيقول البعض إن الشكل والعبادات أركان مهمة في الدين تماما مثل الأخلاق.. الحق أن الأديان جميعا قد وُجِدت أساسا للدفاع عن القيم الإنسانية: الحق والعدل والحرية.. وكل ما عدا ذلك أقل أهمية.. المحزن أن التراث الإسلامي حافل بما يؤكد أن الأخلاق أهم عناصر الدين. لكننا لا نفهم ذلك أو لا نريد أن نفهمه.
هناك قصة شهيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قابل رجلا ناسكا منقطعا للعبادة ليل نهار.. فسأله:
- من ينفق عليك؟
قال الرجل:
- أخي يعمل وينفق علىّ..
عندئذ قال صلى الله عليه وسلم:
- أخوك أعبد منك..
والمعنى هنا قاطع وعظيم.. فالذي يعمل وينفق على أهله أفضل عند الله من الناسك المنقطع للعبادة لكنه لا يعمل. إن الفهم القاصر للدين سبب رئيسي في تردى الأوضاع في مصر. على مدى عشرين عاما امتلأت شوارع مصر ومساجدها بملايين الملصقات تدعو المسلمات إلى الحجاب.. لو أننا تخيلنا أن هذه الملصقات كانت تدعو -بالإضافة للحجاب- إلى رفض الظلم الواقع على المصريين من الحاكم أو الدفاع عن حقوق المعتقلين أو منع تزوير الانتخابات.. لو حدث ذلك لكانت الديمقراطية تحققت في مصر ولانتزع المصريون حقوقهم من الاستبداد..
إن الفضيلة تتحقق بطريقين لا ثالث لهما: إما تدين حقيقي مرادف تماما للأخلاق. وإما عن طريق الأخلاق وحدها حتى ولو لم تستند إلى الدين.. منذ أعوام مرضت والدتي رحمها الله بالسرطان.. فاستدعينا لعلاجها واحدا من أهم أطباء الأورام في العالم، الدكتور جارسيا جيرالت من معهد كوري في باريس.. جاء هذا العالم الكبير إلى مصر عدة مرات لعلاج والدتي ثم رفض بشدة أن يتقاضى أي أتعاب، ولما ألححت عليه قال:
ـ إن ضميري المهني لا يسمح بأن أتقاضى أتعابا مقابل علاج والدة طبيب زميلي.
هذا الرجل لم يكن يعتقد كثيرا في الأديان، لكن تصرفه النبيل الشريف يضعه في أعلى درجة من التدين الحقيقي.. وأتساءل: كم واحدا من كبار أطبائنا المتدينين اليوم سيرد على ذهنه أصلا أن يمتنع عن تقاضي أجره من زميل له؟
مثال آخر، في عام 2007.. بغرض تجميل وجه النظام الليبي أمام العالم.. تم تنظيم جائزة أدبية عالمية سنوية، بقيمة حوالي مليون جنيه مصري، باسم جائزة القذافي لحقوق الإنسان.. وتم تشكيل لجنة من مثقفين عرب كبار لاختيار كاتب عالمي كل عام لمنحه الجائزة.. هذا العام قررت اللجنة منح الجائزة للكاتب الإسباني الكبير خوان جويتيسولو البالغ من العمر 78 عاما..
ثم كانت المفاجأة: فقد أرسل جويتيسولو خطابا إلى أعضاء اللجنة يشكرهم فيه على اختياره للفوز بالجائزة، لكنه أكد في نفس الوقت أنه لا يستطيع -أخلاقيا- أن يتسلم جائزة لحقوق الإنسان من نظام القذافي الذي استولى على الحكم في بلاده بانقلاب عسكري ونكّل -اعتقالا وتعذيبا- بالآلاف من معارضيه.. رفض الكاتب جويتيسولو جائزة بحوالي مليون جنيه مصري؛ لأنها لا تتفق مع ضميره الأخلاقي.. هل نسأل هنا: كم مثقفا أو حتى عالم دين في مصر كان سيرفض الجائزة؟ ومن هو الأقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى؟! هذا الكاتب الشريف الذي أثق في أن الدين لم يخطر على باله وهو يتخذ موقفه الشجاع النبيل، أم عشرات المتدينين المصريين، مسلمين ومسيحيين، الذين يتعاملون مع الأنظمة الاستبدادية ويضعون أنفسهم في خدمتها متجاهلين تماما الجرائم التي ترتكبها تلك الأنظمة في حق شعوبها. إن التدين الحقيقي يجب أن يتطابق مع الأخلاق.. وإلا.. فإن الأخلاق بلا تدين أفضل بكثير من التدين بلا أخلاق..... الديمقراطية هي الحل..










 من طرف
من طرف